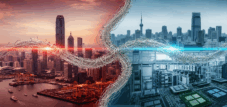أمراء الحرب والذهب والجوع: من المستفيد الحقيقي من الموت الاقتصادي للسودان؟
الإصدار المسبق لـ Xpert
اختيار اللغة 📢
نُشر في: ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ / حُدِّث في: ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ – المؤلف: Konrad Wolfenstein

أمراء الحرب والذهب والجوع: من المستفيد الحقيقي من انهيار الاقتصاد السوداني؟ - صورة إبداعية: Xpert.Digital
200% تضخم ونصف الاقتصاد مدمر: الواقع القاسي للسودان وراء الأرقام
من منارة أمل إلى "دولة فاشلة": القصة المأساوية للانهيار الاقتصادي في السودان
إن فكرة سعي الشركات السودانية للتوسع في السوق الأوروبية في ظلّ الأزمة الراهنة تتعارض مع واقعٍ قاسٍ ومأساوي. فأيُّ نقاشٍ حول استراتيجيات دخول السوق، أو شراكات الأعمال، أو "غزو" الأسواق الألمانية ليس سابقًا لأوانه فحسب، بل هو سوء تقديرٍ جوهري للوضع الكارثي في بلدٍ تعرّضت بنيته الاقتصادية والاجتماعية لتدميرٍ ممنهج. السودان ليس سوقًا صعبًا، بل في ظلّ الظروف الراهنة، لم يعد سوقًا على الإطلاق.
أدت الحرب الأهلية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، والمستعرة منذ أبريل/نيسان 2023، إلى انهيار اقتصادي شامل. وترسم الأرقام صورةً قاتمة: فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 42%، وارتفع معدل التضخم إلى 200%، وفُقد 5.2 مليون وظيفة - أي نصف الوظائف المتاحة. أما العاصمة الخرطوم، التي كانت تُعتبر القلب الاقتصادي للبلاد، فقد تحولت إلى أنقاض بعد قرابة عامين من القتال المتواصل.
لكن وراء هذه الأرقام المجردة تكمن مأساة إنسانية ذات أبعاد عالمية. فمع وجود أكثر من 30 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة و12.9 مليون نازح، يشهد السودان أكبر أزمة لاجئين في العالم. وتتفشى المجاعة على نطاق واسع في معظم أنحاء البلاد. ولم يُضعف الاقتصاد فحسب، بل تحول إلى اقتصاد حرب، حيث يُموّل أمراء الحرب آلتهم الحربية بنهب الموارد، كالذهب، وخنق أي ريادة أعمال مدنية.
لذا، لا تُعدّ هذه المقالة دليلاً على استحالة دخول السوق، بل هي تحليلٌ دقيقٌ للانهيار الاقتصادي، مُسلّطةً الضوء على الأسباب الهيكلية التي أدت إلى تراجع دور السودان كشريكٍ تجاري. وتبحث المقالة في كيفية تبديد مستقبلٍ واعد، وكيفية عمل اقتصاد الحرب، ولماذا يعتمد أي أملٍ في التعافي الاقتصادي على انتهاء الصراع وعقودٍ من إعادة الإعمار الشاقة.
من الجوهر إلى التكهن: لماذا لا يسمح الواقع الاقتصادي السوداني بالتوسع الأوروبي؟
تواجه مسألة فرص التوسع للشركات السودانية في الأسواق الألمانية والأوروبية حقيقةً مُقلقة: يفتقر السودان حاليًا إلى قاعدة متينة من القطاع الخاص تُبرر أو تُمكّن من توسع الأعمال التجارية الدولية. فالحرب الأهلية المُستعرة منذ أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية لم تُدمر البلاد ماديًا فحسب، بل قضت أيضًا على أي بنية تحتية تجارية قائمة. الوضع الاقتصادي ليس صعبًا فحسب، بل هو كارثي لدرجة أن أي نقاش حول استراتيجيات دخول الأسواق الأوروبية يُصبح مُستهجنًا.
الأرقام الصارخة تتحدث عن نفسها: انخفض الناتج المحلي الإجمالي للسودان من 56.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى ما يُقدر بـ 32.4 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025 - بخسارة تراكمية قدرها 42% من إجمالي الناتج الاقتصادي. وصل معدل التضخم إلى مستوى فلكي بلغ 200% في عام 2024، وفي الوقت نفسه فُقد 5.2 مليون وظيفة - أي نصف إجمالي القوى العاملة. هذا ليس انكماشًا اقتصاديًا، بل انهيار اقتصادي شامل. يحتاج أكثر من 30 مليون شخص - أي أكثر من 60% من السكان - إلى مساعدات إنسانية، و12.9 مليون نازح، وتعاني 14 منطقة على الأقل من مجاعة حادة.
إن الحديث عن "صناعات وشركات سودانية" قادرة على "توسيع أعمالها في أوروبا" في ظل هذه الظروف يُشوّه الواقع تمامًا. لم يبقَ تقريبًا أي شركات سودانية عاملة قادرة على تجاوز مجرد البقاء. انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 70%، وانخفضت القيمة المضافة الزراعية بنسبة 49%. حتى الشركات الكبيرة القليلة التي كانت قائمة قبل الحرب - مثل مجموعة دال - أوقفت عملياتها أو نقلتها. انهارت البنية التحتية المصرفية، وانقطعت طرق التجارة، والعاصمة الخرطوم، التي كانت تُعتبر في السابق القلب الاقتصادي للبلاد، أصبحت الآن في حالة خراب.
ولذلك فإن هذا التحليل لا يدرس فرص التوسع السوداني الوهمي في أوروبا، بل يبحث في الأسباب البنيوية التي تجعل السودان غير موجود بشكل فعال كشريك اقتصادي في ظل الظروف الحالية ــ وما هي التحولات الجوهرية التي ستكون ضرورية حتى نتمكن من التفكير في العلاقات التجارية الدولية مرة أخرى.
من منارة أمل إلى منطقة حرب: الدمار الاقتصادي لبلد
لا تكمن مأساة السودان في الكارثة الحالية فحسب، بل تكمن أيضًا في الفرصة الضائعة. ففي عام ٢٠١٩، بعد الإطاحة بالديكتاتور عمر البشير، بدأ الأمل الدولي ينبثق. نظّمت ألمانيا مؤتمر شراكة السودان في يونيو ٢٠٢٠، حيث تعهّد الشركاء الدوليون بتقديم ما مجموعه ١.٨ مليار دولار أمريكي لدعم عملية التحول. وفي عام ٢٠٢١، منح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السودان إعفاءً من ديونه بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مما أدى إلى خفض ديونه الخارجية من ٥٦.٦ مليار دولار أمريكي إلى حوالي ٦ مليارات دولار أمريكي. وبدا وكأن السودان، بعد عقود من العزلة، قد يصبح شريكًا مستقرًا.
تبددت هذه الآمال بانقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021 العسكري، حين استولى الجنرال عبد الفتاح البرهان على السلطة وأطاح بالحكومة الانتقالية المدنية. فُصلت المساعدات الدولية، وعُلقت برامج التنمية. لكن الكارثة الحقيقية بدأت في أبريل/نيسان 2023، حين اندلع الصراع على السلطة بين جيش البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو، متحولًا إلى حرب أهلية.
كانت العواقب الاقتصادية مدمرة وسريعةً بشكل غير مسبوق. كان الإنتاج الصناعي يتركز تقليديًا في منطقة الخرطوم الكبرى، تحديدًا حيث دارت أشرس المعارك. نُهبت المصانع، ودُمّرت الآلات أو سُرقت، وقُصفت مرافق الإنتاج. استمرت معركة الخرطوم قرابة عامين، وتُعتبر واحدة من أطول المعارك وأكثرها دمويةً في عاصمة أفريقية، حيث سقط أكثر من 61 ألف قتيل في منطقة العاصمة وحدها. لم ينجح الجيش إلى حد كبير في طرد قوات الدعم السريع من الخرطوم إلا في مارس 2025، ولكن بحلول ذلك الوقت كانت المدينة قد أصبحت بالفعل مجرد هيكلٍ مُدمرٍ لما كانت عليه في السابق.
كما تكبد قطاع الزراعة، الذي كان يساهم قبل الحرب بنحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 80% من القوى العاملة، خسائر فادحة. وانخفض إنتاج الحبوب في عام 2024 بنسبة 46% عن مستواه في عام 2023، وبنسبة 40% عن متوسط السنوات الخمس. ولم يتمكن العديد من المزارعين من زراعة حقولهم إما لفرارهم أو لأن المناطق أصبحت ساحات معارك. وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل حاد، فأصبح الأرز والفاصوليا والسكر غير متوافرين في بعض المناطق، بينما تضاعفت أسعار اللحوم بأكثر من الضعف.
لقد جُرِّم قطاع الذهب، الذي كان يُدرّ نحو 70% من عائدات التصدير، بشكل فعلي. سيطر كلا الطرفين المتحاربين - الجيش وقوات الدعم السريع - على مناجم الذهب ويستخدمان عائداتها لتمويل حربهما. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 80% و85% من الذهب السوداني يُهرَّب إلى الخارج، وخاصةً إلى الإمارات العربية المتحدة. ولا تعكس صادرات الذهب الرسمية إلى الإمارات، والبالغة 750.8 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، سوى جزء ضئيل من حجم التجارة الفعلي. ويحول اقتصاد الحرب هذا دون أي تنمية اقتصادية منظمة، وقد حوّل السودان إلى دولة فاشلة، حيث سيطرت الجريمة المنظمة وعصابات أمراء الحرب.
كانت العلاقات الاقتصادية الألمانية السودانية، التي تطورت تاريخيًا، هامشية قبل الحرب. ففي عام ٢٠٢١، بلغ حجم التجارة الثنائية ١٢٨ مليون يورو فقط. ولم تُشكل صادرات السودان التقليدية إلى ألمانيا - القطن والصمغ العربي والسمسم - سوى جزء ضئيل من حجم واردات ألمانيا. في المقابل، استورد السودان بشكل رئيسي الآلات والمعدات والسلع النهائية من ألمانيا. ومنذ اندلاع الحرب، توقفت هذه التجارة المتواضعة تقريبًا، حيث تُظهر إحصاءات المملكة المتحدة أن حتى التجارة البريطانية مع السودان - وإن كانت منخفضة المستوى - أصبحت الآن تتكون بالكامل تقريبًا من السلع الإنسانية.
تكشف التطورات التاريخية عن نمط من الفرص الضائعة: صحيح أن السودان امتلك إمكانات اقتصادية بعد استقلاله عام ١٩٥٦، لكنه بددها على مدى عقود من الحرب الأهلية وسوء الإدارة والعقوبات الدولية. وانتهت فترة الأمل القصيرة بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢١ بنهاية وحشية نتيجة تجدد الحكم العسكري والحرب. ويمثل الوضع الحالي انحدارًا تاريخيًا، وسيستغرق التعافي منه - حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلًا - عقودًا.
تشريح الانهيار: اقتصاديات الحرب ومستفيدوها
يتبع الانهيار الاقتصادي السوداني آلياتٍ محددة تتجاوز بكثير حالات الركود الاقتصادي الاعتيادية. يكمن جوهره في التحول من اقتصاد السوق - وإن كان هشًا - إلى اقتصاد حربي تسيطر عليه جهتان عسكريتان، هدفهما الاقتصادي الوحيد هو تمويل آلتهما الحربية.
سيطرت قوات الدعم السريع، بقيادة الفريق أول دقلو، على مناجم الذهب المربحة في دارفور وشمال كردفان. تسيطر هذه الميليشيا شبه العسكرية، المنبثقة عن فرسان الجنجويد سيئي السمعة، على مساحات شاسعة من مناطق تعدين الذهب الغربية. وتشير التقديرات إلى أنه في عام 2024 وحده، استخرجت المناجم التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور ذهبًا بقيمة 860 مليون دولار أمريكي. يُهرَّب معظم هذا المبلغ بشكل غير قانوني إلى الإمارات العربية المتحدة، التي تُزوّدها بالأسلحة والذخيرة في المقابل، وهو مثال صارخ على لعنة الموارد التي تُديم الصراع المسلح.
تسيطر القوات المسلحة السودانية بدورها على البنية التحتية الاستراتيجية والموانئ والمؤسسات الحكومية، ما دامت هذه الأخيرة لا تزال تعمل. يُعد ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، وهو أهم ميناء بحري في البلاد، نقطة عبور لصادرات النفط والذهب، بالإضافة إلى واردات الأسلحة. لا يرغب أيٌّ من طرفي الحرب في اقتصاد مدني فعال، وهذا من شأنه أن يُعرّض سيطرتهما على الموارد ومصادر الدخل للخطر.
بالنسبة للسكان المدنيين المتبقين والشركات القليلة المتبقية، يُمثل اقتصاد الحرب هذا استيلاءً فعليًا على الممتلكات. تُفيد المنظمات الدولية عن أعمال نهب ممنهج من كلا الجانبين، وابتزاز، واعتقالات تعسفية، ومصادرة للسلع ووسائل الإنتاج. لا تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُشكل العمود الفقري لأي اقتصاد فاعل، العمل في ظل هذه الظروف. وقد أوقفت مجموعة دال، إحدى أكبر التكتلات الخاصة في السودان، والتي تعمل في مجال إنتاج الأغذية وقطاعات أخرى، إنتاجها أو نقلته إلى مواقع أكثر أمانًا.
تعكس مؤشرات الاقتصاد الكلي هذا الانهيار المؤسسي. نتج معدل التضخم البالغ 200% في عام 2024 عن مزيج من طباعة النقود لتمويل الحروب، واضطرابات الاستيراد، وانهيار الجنيه السوداني. سعر الصرف الرسمي لا قيمة له؛ وتُعرض أسعار أسوأ بكثير في السوق السوداء. هذا يجعل أي حساب للأعمال الموجهة نحو الاستيراد أو التصدير مستحيلاً. لم تعد العملة مخزنًا للقيمة، بل مجرد وسيط تبادل سريع الانخفاض.
وصلت البطالة إلى مستويات كارثية، مع فقدان 5.2 مليون وظيفة، أي ما يقارب نصف إجمالي الوظائف الرسمية. ويتفاقم الوضع بشكل خاص في قطاعي الخدمات والصناعة، اللذين يتركزان في الخرطوم ومحيطها. وقد فرّ العديد من العمال أو لم تعد لديهم وظائف يمكنهم العودة إليها. كما انهار الاقتصاد غير الرسمي، الذي كان يُمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي حتى قبل الحرب، بشكل كبير، مع تقييد الحركة وتوقف الأسواق عن العمل.
لقد انهار النظام المصرفي - وهو شرط أساسي لأي نشاط اقتصادي حديث - بشكل فعلي. أجهزة الصراف الآلي معطلة، والتحويلات الدولية شبه مستحيلة، والقروض متوقفة. حتى المعاملات التجارية البسيطة يجب أن تُجرى نقدًا، وهو أمر غير عملي في ظل التضخم الجامح وعدم اليقين. العقوبات الدولية، بما في ذلك حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول، تزيد من تعقيد أي تعاملات تجارية عبر الحدود.
يكشف الميزان التجاري عن خلل هيكلي: ففي النصف الأول من عام 2025، صدّرت السودان بشكل رئيسي الذهب (750.8 مليون دولار أمريكي إلى الإمارات العربية المتحدة)، والحيوانات الحية (159.1 مليون دولار أمريكي إلى السعودية)، والسمسم (52.6 مليون دولار أمريكي إلى مصر). وتألفت الواردات بشكل رئيسي من الآلات من الصين (656.5 مليون دولار أمريكي)، والمواد الغذائية من مصر (470.7 مليون دولار أمريكي)، والمواد الكيميائية من الهند (303.6 مليون دولار أمريكي). وهذا يُظهر أنه حتى في حالة الحرب، يُصدر السودان المواد الخام ويستورد السلع النهائية - وهو نمط تجاري استعماري لا يُوفر أساسًا للتنمية الصناعية أو الصادرات عالية القيمة.
الأطراف الفاعلة في هذا النظام مُحددة بوضوح: الجيش والميليشيات تسيطر على قطاعات مربحة كالذهب والنفط؛ وشبكات التهريب الدولية تضمن الصادرات غير المشروعة؛ والدول المجاورة - وخاصة الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية - تستفيد من شراء المواد الخام الرخيصة وتوريد الأسلحة باهظة الثمن. المجتمع المدني ورجال الأعمال ضحايا في هذه المعادلة، وليسوا أطرافًا فاعلة. لا يوجد ما يشير إلى وجود طبقة متوسطة ريادية قادرة على غزو الأسواق العالمية.
مشهد من الأنقاض بدلاً من بيئة الأعمال: الوضع الراهن في نوفمبر 2025
في نوفمبر 2025، يُصبح الوضع الاقتصادي في السودان كارثة إنسانية واقتصادية ذات أبعاد تاريخية. تشهد البلاد أكبر أزمة نزوح في العالم، وإحدى أسوأ المجاعات في التاريخ الحديث.
تُشير أهم المؤشرات الكمية إلى صورة قاتمة: من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 32.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025، أي أقل بنسبة 42% عن مستواه قبل الحرب في عام 2022. ويتراوح معدل التضخم بين 118% و200%، مما يُبدد المدخرات ويجعل أي حساب للأسعار مستحيلاً. وقد انخفض دخل الفرد من 1147 دولارًا أمريكيًا (2022) إلى ما يُقدر بـ 624 دولارًا أمريكيًا (2025). وهذا يضع السودان بين أفقر دول العالم.
يفوق البعد الإنساني التصور: 30.4 مليون شخص - أي أكثر من نصف إجمالي عدد السكان المقدر بخمسين مليون نسمة - يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. تُعدّ هذه أكبر أزمة إنسانية في العالم. 12.9 مليون شخص نازح، منهم 8.9 مليون نازح داخلي و4 ملايين لاجئ في الدول المجاورة. استقبلت مصر العدد الأكبر من السودانيين (ما يُقدر بـ 1.2 مليون نازح)، تليها تشاد (مليون نسمة)، وجنوب السودان (مليون نسمة)، ودول مجاورة أخرى.
الوضع الغذائي كارثي: يعاني 24.6 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويواجه 637 ألف شخص - وهو أعلى رقم عالمي - مجاعة كارثية. أُعلنت المجاعة رسميًا في مخيم زمزم بشمال دارفور في أغسطس/آب 2024، وهي الأولى من نوعها منذ سنوات. وتواجه 14 منطقة أخرى على الأقل خطر المجاعة. ويعاني أكثر من ثلث الأطفال من سوء التغذية الحاد، حيث يتجاوز المعدل في العديد من المناطق عتبة الـ 20% التي تُعرّف المجاعة.
دُمِّرت البنية التحتية في أنحاء واسعة من البلاد. في الخرطوم، العاصمة الاقتصادية والسياسية، التي كانت تضم في السابق أكثر من ستة ملايين نسمة، تحولت أحياء بأكملها إلى أنقاض. قُصفت المباني السكنية، ونُهبت المستشفيات، وحُوِّلت المدارس إلى قواعد عسكرية. أُجبر 31% من سكان المدن على النزوح. تضررت شبكة الطرق بسبب القتال، ودُمرت الجسور أو أغلقها الجيش. لم يسترد الجيش مطار الخرطوم إلا في نهاية مارس/آذار 2025، ولكنه لم يُفعَّل بعد.
لم تعد إمدادات الكهرباء والمياه موثوقة في معظم المراكز الحضرية. هذا لا يُعيق الحياة اليومية فحسب، بل يُعيق أي إنتاج صناعي. تُضطر المستشفيات للعمل بمولدات الطوارئ، إن وُجدت أصلاً. انهار نظام الرعاية الصحية: أُغلقت العديد من المرافق الصحية، أو نُهبت، أو دُمرت. الأدوية شحيحة. استفحل وباء الكوليرا والحصبة منذ عام ٢٠٢٤؛ وبحلول أبريل ٢٠٢٥، سُجلت ما يقرب من ٦٠ ألف حالة كوليرا، وأكثر من ١٦٤٠ حالة وفاة.
البنية التحتية التعليمية في حالة خراب أيضًا. أُغلقت المدارس والجامعات منذ بداية الحرب، أو استُخدمت كملاجئ طارئة للنازحين. جيل كامل من الأطفال والشباب محرومون من التعليم. وسيكون لهذا عواقب بعيدة المدى على تنمية رأس المال البشري، وسيعيق أي انتعاش اقتصادي.
بالنسبة للشركات، يعني هذا الوضع الراهن انعدام بيئة الأعمال. لا يوجد استقرار قانوني، ولا مؤسسات موثوقة، ولا تنفيذ للعقود. حتى في المناطق الأقل تأثرًا بالحرب، مثل ولاية البحر الأحمر حيث تقع بورتسودان، فإن العمليات التجارية العادية مستحيلة. على الرغم من أن المدينة الساحلية تخضع لسيطرة الجيش واستقبلت العديد من اللاجئين من الخرطوم، إلا أنها تعاني من الاكتظاظ السكاني والتضخم وانعدام الأمن المستمر. حتى هنا، ارتفعت تكلفة المعيشة بشكل كبير - حيث يبلغ سعر كيلوغرام اللحم 26,000 جنيه سوداني (43 دولارًا أمريكيًا)، أي ما يقرب من ضعف سعره قبل الحرب.
يمكن تلخيص التحديات الأكثر إلحاحًا على النحو التالي: أولًا، ضمان بقاء ملايين الأشخاص المهددين بالجوع والمرض والعنف على قيد الحياة فورًا. ثانيًا، إنهاء الأعمال العدائية ووقف إطلاق نار مستدام - وهو أمر لا توجد أي بوادر له حاليًا. ثالثًا، الاستعادة التدريجية لوظائف الدولة الأساسية وبنيتها التحتية. رابعًا، التحول الاقتصادي طويل الأمد، الذي يعني التحول من اقتصاد الحرب والاعتماد على المواد الخام إلى نشاط اقتصادي متنوع ومنتج. ثمة فجوة شاسعة بين الوضع الراهن وهذا الهدف طويل الأمد، فجوة لا يمكن لأي مفهوم تسويقي، مهما كان طموحًا، أن يسدها.
خبرتنا الصناعية والاقتصادية العالمية في تطوير الأعمال والمبيعات والتسويق
التركيز على الصناعة: B2B، والرقمنة (من الذكاء الاصطناعي إلى الواقع المعزز)، والهندسة الميكانيكية، والخدمات اللوجستية، والطاقات المتجددة والصناعة
المزيد عنها هنا:
مركز موضوعي يضم رؤى وخبرات:
- منصة المعرفة حول الاقتصاد العالمي والإقليمي والابتكار والاتجاهات الخاصة بالصناعة
- مجموعة من التحليلات والاندفاعات والمعلومات الأساسية من مجالات تركيزنا
- مكان للخبرة والمعلومات حول التطورات الحالية في مجال الأعمال والتكنولوجيا
- مركز موضوعي للشركات التي ترغب في التعرف على الأسواق والرقمنة وابتكارات الصناعة
من الصمغ العربي إلى الذهب – لماذا يفشل السودان في السوق الأوروبية؟
وهم التوسع: لماذا لا تستطيع الشركات السودانية القدوم إلى أوروبا؟
إن التقييم الرصين للصناعات والشركات السودانية التي قد تسعى لتوسيع أعمالها في ألمانيا وأوروبا يقود إلى إجابة واضحة: لا يوجد أيٌّ منها. إن فكرة أن الشركات السودانية قد تتخذ من ألمانيا "نقطة انطلاق لغزو الأسواق الألمانية والأوروبية" في الوضع الحالي تفتقر تمامًا إلى أي أساس واقعي. كما أن الشركات السودانية العاملة ذات القدرات التصديرية غير موجودة، ولن تكون قادرة على تلبية المتطلبات التنظيمية واللوجستية ورأس المال المعقدة لدخول السوق الأوروبية.
لننظر إلى القطاعات الأكثر إثارة للاهتمام من الناحية النظرية. يُعدّ الصمغ العربي تقليديًا منتجًا تصديريًا ذا إمكانات عالية. يُنتج السودان ما يقارب 70 إلى 80% من الصمغ العربي في العالم، والذي يُستخدم في صناعة الأغذية والمشروبات. مع ذلك، انخفض الإنتاج بشكل حاد منذ بداية الحرب، ويخضع لسيطرة الفصائل المتحاربة. تعطلت سلاسل التوريد، وتوقفت ضوابط الجودة، وتُجرى عمليات المعالجة - إن وُجدت أصلًا - في ظلّ أبسط الظروف. يُعدّ دخول سوق الأغذية الأوروبية شديدة التنظيم، والتي تتطلب شهادات وتتبعًا دقيقين، أمرًا مستحيلًا.
الوضع مشابه للسمسم، حيث كان السودان تاريخيًا من أكبر مُصدّريه، إذ يُمثّل 40% من الإنتاج الأفريقي. مع ذلك، تقع مناطق زراعة السمسم في مناطق حرب، وقد انخفض الحصاد بشكل حاد، والصادرات القليلة المتبقية تذهب إلى الصين واليابان والدول المجاورة، وليس إلى أوروبا. يقتصر خلق القيمة على صادرات المواد الخام؛ فلا توجد معالجة، ولا علامات تجارية، ولا تمييز للمنتجات. ستضطر أي شركة سودانية ترغب في تسويق منتجات السمسم في أوروبا إلى منافسة موردين مُخضرمين من الهند وميانمار وأمريكا اللاتينية - وهي مهمة مستحيلة بالنسبة لمنتج مزقته الحرب ويفتقر إلى رأس المال والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق.
قطاع الذهب هو القطاع الوحيد الذي لا يزال يُنتج كميات كبيرة من الصادرات، ولكن هذا يحدث بشكل غير قانوني ويُموّل الحروب. سيواجه تجار الذهب السودانيون الراغبون في التصدير إلى أوروبا عقوبات دولية ولوائح لمكافحة غسل الأموال فورًا. ستمنع عملية كيمبرلي وآليات التصديق المماثلة للمعادن الممنوحة للصراع أي تجارة. حتى لو أمكن تصدير الذهب "النظيف"، ستكون المنافسة من مصافي الذهب العريقة في سويسرا وألمانيا والمملكة المتحدة هائلة.
تُعدّ تربية الماشية قطاعًا تقليديًا آخر ذا إمكانات نظرية، فالسودان يمتلك أحد أكبر تجمعات الثروة الحيوانية في أفريقيا، وتشكل صادرات الحيوانات الحية جزءًا كبيرًا من عائدات صادراته، لا سيما إلى الدول العربية. ومع ذلك، يخضع تصدير الحيوانات الحية إلى أوروبا لرقابة شديدة، ويثير جدلًا متزايدًا بسبب مخاوف تتعلق برعاية الحيوان والصحة البيطرية. وحتى لو استطاع المصدرون السودانيون استيفاء المعايير الأوروبية، فسيكون هذا العمل منخفض هامش الربح، ويواجه عقبات لوجستية كبيرة. أما منتجات اللحوم المصنعة من السودان، والتي من شأنها أن تسمح بهوامش ربح أعلى، فهي غير واردة حاليًا، نظرًا لتدمير البنية التحتية للمعالجة، وعدم القدرة على الحفاظ على معايير النظافة.
الشركات الكبيرة القليلة المتبقية في السودان - مثل بنك الخرطوم، وشركة الاتصالات السودانية، وشركات النفط المملوكة للدولة - تعمل، إن وُجدت، محليًا فقط، وتكافح من أجل البقاء. تفتقر هذه الشركات إلى الموارد والتركيز الاستراتيجي اللازمين للتوسع الدولي. كما أن معظمها مملوك للدولة، ويخضع لعقوبات دولية، أو على الأقل لإجراءات تدقيق نفي مشددة من جانب البنوك الغربية.
تُشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُشكل عصب الاقتصاد وتُحفز الابتكار في أعمال التصدير في العديد من الدول النامية، حاليًا في السودان في مراحلها الأولى. خلال الحرب، ظهرت مئات الشركات الصغيرة، مُنتجةً الضروريات الأساسية مثل منتجات الألبان ومواد التعبئة والتغليف والمنظفات. ومع ذلك، تُركز هذه الشركات على الأسواق المحلية، وغالبًا ما تستخدم تقنيات بدائية، ومواردها محدودة للغاية، وتفتقر إلى الخبرة في التصدير أو الأعمال التجارية الدولية. إن فكرة أن مُنتجًا سودانيًا صغيرًا للأواني الفخارية أو الصابون يُمكنه غزو السوق الألمانية فكرة سخيفة.
إن المقارنة بقصص التوسع الأفريقي الناجحة تجعل استحالة تحقيق ذلك أوضح. فقد حققت شركات التكنولوجيا الناشئة الكينية، ومصدّرو القهوة الإثيوبيون، وموردي السيارات المغاربة نجاحهم في دول فاعلة تتمتع باستقرار سياسي نسبي، وبنية تحتية متطورة، وإمكانية الوصول إلى رأس المال. أما السودان، فلا يقدم أيًا من ذلك. حتى دول مثل جنوب السودان أو الصومال، التي تعاني أيضًا من الصراعات، تتمتع ببعض الاستقرار على الأقل في بعض المناطق، وتمكنت من الحفاظ على هياكل اقتصادية بدائية. أما السودان، فهو في حالة انهيار تام.
تواجه الشركات السودانية عقبات تنظيمية وعملية هائلة عند دخولها السوق الأوروبية. تشترط لوائح الاستيراد الأوروبية إثبات المنشأ، وشهادات الجودة، والتخليص الجمركي، والامتثال لمعايير المنتج. سيجري شركاء الأعمال الألمان عمليات تدقيق واجبة، مما يثير تساؤلات حول تسجيل الشركة، والقوائم المالية، والسجلات الضريبية، والسمعة. لا تستطيع أي شركة سودانية حاليًا استيفاء أي من هذه المتطلبات. حتى تحويلات الأموال ستُشكل مشكلة، نظرًا لاختلال النظام المصرفي السوداني، وسترفض البنوك الدولية المعاملات من السودان بسبب العقوبات ومخاطر غسل الأموال.
إن فكرة وجود "شريك ألماني قوي ومتخصص في التسويق والعلاقات العامة وتطوير الأعمال" لا تحل هذه المشاكل الجوهرية. فالتسويق لا يستطيع بيع منتج غير موجود. والعلاقات العامة لا تستطيع تحويل بلد مزقته الحرب إلى شريك تجاري جذاب. ولا يمكن لتطوير الأعمال بناء علاقات تجارية في غياب الأعمال. وينصح أي مزود خدمة ألماني حسن السمعة بعدم التعاون مع "شركاء" سودانيين، لأن مخاطر السمعة، والغموض القانوني، والاستحالة العملية ستدمر أي مشروع تجاري محتمل.
تحليل مقارن: عندما تدمر الحرب الاقتصاد
إن إلقاء نظرة على الدول الأخرى المتضررة من النزاعات المسلحة أو الأزمات الاقتصادية يُبرز الطبيعة الفريدة للوضع السوداني ومأساة البلاد. ويكشف التحليل المقارن عن الظروف التي يُتاح فيها التعافي الاقتصادي، ولماذا يعجز السودان حاليًا عن استيفاء هذه الظروف.
شهدت سوريا حربًا أهلية أطول وأكثر دموية، مستمرة منذ عام ٢٠١١. ومع ذلك، حتى في سوريا، نجت هياكل اقتصادية بدائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. تواصل دمشق ومدن أخرى عملها، وإن كان على نطاق محدود. يحافظ المصدرون السوريون، ومعظمهم من الشتات، على علاقات تجارية، وتصل المنتجات السورية - زيت الزيتون والمنسوجات والمواد الغذائية - إلى الأسواق العالمية، غالبًا عبر دول ثالثة. الفرق الجوهري هو أن سوريا لديها حكومة فاعلة تسيطر على أراضيها، وشتات ذو رأس مال وشبكات دولية. أما السودان، فلا يملك أيًا منهما بدرجة كافية.
تُقدم أوكرانيا مقارنة مختلفة: بلدٌ في حالة حرب، ومع ذلك يسعى إلى الحفاظ على علاقاته الاقتصادية وجذب المستثمرين الدوليين. تواصل الشركات الأوكرانية تصدير الحبوب ومنتجات الصلب وخدمات تكنولوجيا المعلومات. وتناقش المؤتمرات الدولية إعادة الإعمار وتحشد مليارات الدولارات كمساعدات. تتمتع أوكرانيا بدعم غربي هائل، ولديها بنية تحتية متطورة نسبيًا (رغم أضرار الحرب)، ونظام تعليمي، وإدارة فعّالة في أجزاء كبيرة من البلاد. علاوة على ذلك، تُقاتل أوكرانيا ضد مُعتدٍ خارجي، مما يُحشد التضامن الدولي. من ناحية أخرى، يشهد السودان حربًا أهلية يرتكب فيها كلا الجانبين جرائم حرب، والتعاطف الدولي محدود.
ربما يكون الصومال المثال الأبرز: بلدٌ عانى من عقود من الحرب الأهلية وانهيار الدولة. ومع ذلك، لم يشهد الصومال تنميةً اقتصاديةً تُذكر في بعض مناطقه، لا سيما في أرض الصومال المستقرة نسبيًا. وتزدهر تربية الماشية، وخدمات تحويل الأموال، والتجارة المحلية. وتتمتع الجاليات الصومالية في أوروبا وأمريكا الشمالية بقوةٍ واستثمارٍ كبيرين في وطنها. أما الجالية السودانية في الخارج، فهي أصغر حجمًا وأقل ترابطًا، والصراع فيها أوسع انتشارًا، مما لا يترك مناطق فرعية آمنةً تزدهر فيها الأنشطة الاقتصادية.
تُعدّ رواندا، بعد الإبادة الجماعية عام ١٩٩٤، مثالاً على التحوّل الناجح الذي أعقب عنفاً كارثياً. فقد شهدت البلاد مقتل ما يقارب مليون شخص في غضون بضعة أشهر. ومع ذلك، فقد حققت انتعاشاً ملحوظاً، بفضل حكم قوي (وإن كان استبدادياً)، ومساعدات دولية، واستثمارات في التعليم والبنية التحتية، وسياسة مدروسة للمصالحة والتنمية الاقتصادية. يفتقر السودان إلى جميع هذه الشروط الأساسية: لا توجد حكومة معترف بها تتمتع بالسلطة والشرعية، والمساعدات الدولية محدودة وغالباً ما تُمنع، والتعليم غائب، والمصالحة مستحيلة في ظل العنف المستمر.
يُقدم العراق بعد عام ٢٠٠٣ مقارنة أخرى: بلدٌ مزقته الحرب، ببنية تحتية مدمرة، لكنه يمتلك احتياطيات نفطية هائلة موّلت إعادة الإعمار. عادت الشركات العالمية، مُغرمة بعقود النفط والبناء. الفرق الجوهري: كان للعراق صناعة نفطية فعّالة ومساعدات عسكرية وتنموية دولية ضخمة. أما السودان، فقد فقد معظم احتياطياته النفطية مع استقلال جنوب السودان عام ٢٠١١؛ ويستغلّ الأطراف المتحاربة ما تبقى من النفط، وليس لإعادة الإعمار.
اليمن، كما هو الحال في السودان، غارق في حرب أهلية ضارية، مما يُظهر مخاطر اقتصاد الحرب طويل الأمد. هناك أيضًا، تسيطر فصائل مختلفة (الحوثيون، والحكومة المدعومة من السعودية) على أجزاء من البلاد، وتعتمد على تصدير المواد الخام والتهريب والمساعدات الخارجية. لقد انهار الاقتصاد، ويعاني السكان من الجوع والمرض. تُظهر المقارنة أنه بدون حل سياسي، لا مستقبل اقتصادي. يُواجه السودان خطر أن يصبح "يمنًا ثانيًا" - دولة فاشلة تعيش في حرب أهلية دائمة وأزمة إنسانية مُستمرة.
يُظهر التحليل أن التعافي الاقتصادي بعد الصراع ممكن، لكنه يتطلب شروطًا محددة: دولة فاعلة (حتى لو كانت استبدادية)، وسيطرة على عائدات الموارد لتمويل إعادة الإعمار، ودعم دولي واسع، وشعب متعلم وقادر، وحد أدنى من الأمن والقدرة على التنبؤ. لا يستوفي السودان أيًا من هذه الشروط. بل إنه يجمع أسوأ العوامل: حرب مستمرة، وحكم مجزأ، ونهب للموارد من قبل الأطراف المتحاربة، وغياب الأولوية الدولية، ونزوح جماعي للطبقة المتعلمة، وانعدام الأمن التام. إن الحديث عن تطوير الأعمال أو توسيع السوق في هذا السياق ليس فقط غير واقعي، بل مثير للسخرية أيضًا.
الحقائق غير المريحة: المخاطر، والتبعيات، والتشوهات الهيكلية
إن التقييم النقدي للوضع الاقتصادي في السودان يقودنا إلى العديد من الحقائق غير المريحة التي غالبا ما يتم تجاهلها في خطابات التنمية الملطفة.
أولاً، اقتصاد الحرب مُربح لبعض الأطراف. يُعتبر الفريق أول دقلو، قائد قوات الدعم السريع، من أغنى أغنياء السودان، بثروة جناها من تجارة الذهب وامتلاك الأراضي. تستفيد الإمارات العربية المتحدة من الذهب السوداني الرخيص وتبيع أسلحة باهظة الثمن في المقابل. يستغل التجار المصريون محنة اللاجئين السودانيين. يسيطر أمراء الحرب في دارفور على المناجم وطرق التهريب. لا يكترث هؤلاء بالسلام وسيادة القانون، لأن ذلك من شأنه أن يُعرّض أرباحهم للخطر. ما دامت هياكل الحوافز تُكافئ الحرب، فستستمر. هذه هي "لعنة الموارد" في أنقى صورها: ثروة الموارد - وخاصة السلع سهلة الاستخراج والتهريب مثل الذهب - تجعل الحرب مربحة وتُديمها.
ثانيًا، تخلى المجتمع الدولي إلى حد كبير عن السودان. فبينما تحظى أوكرانيا وغزة باهتمام ومساعدات دولية كبيرة، يُعدّ السودان "صراعًا منسيًا". وتتعدد أسباب ذلك: عدم أهميته الجيوسياسية (فالسودان ليس ذا أهمية سياسية في مجال الطاقة ولا مركزًا استراتيجيًا)، وإرهاق الصراع بعد عقود من الأزمات السودانية، والتسلسلات الهرمية العنصرية في اقتصاد الاهتمام الدولي، وتعقيد حرب أهلية دون وجود "أطراف خيرة" و"شريرة" واضحة. والنتيجة: تعاني المساعدات الإنسانية من نقص حاد في التمويل. ففي عام ٢٠٢٤، لم يتلقَّ السودان سوى ثلث المبلغ المطلوب للمساعدات الإنسانية والبالغ ٤.٢ مليار دولار أمريكي. وتوقفت مساعدات التنمية تقريبًا. ويعني هذا الإهمال الدولي أن السودان لا يمكنه أن يتوقع الحصول على مساعدات إعادة إعمار على غرار "خطة مارشال" التي مُنحت لدول أخرى تعاني من أزمات.
ثالثًا، العواقب البيئية والديموغرافية طويلة المدى مدمرة. ملايين الأطفال محرومون من التعليم؛ جيل كامل ينشأ وسط العنف والجوع واليأس. الصدمة واسعة النطاق. في الوقت نفسه، تتدهور البيئة والموارد الزراعية بسبب الاستغلال الجائر، ونقص صيانة أنظمة الري، وتغير المناخ. التصحر يتسارع. عندما تنتهي الحرب، سيُترك السودان مع سكان غير متعلمين ومصدومين، وموارد طبيعية متدهورة - وهو ما لا يُمثل أساسًا جيدًا للتنمية.
رابعًا: تُعمّق الحرب التشرذم الاجتماعي والانقسام العرقي. تُتّهم قوات الدعم السريع بارتكاب تطهير عرقي في دارفور ضد السكان غير العرب. يُقصف الجيش المناطق المدنية قصفًا عشوائيًا. يستخدم كلا الجانبين العنف الجنسي كسلاح حرب. تُخلّف هذه الفظائع شرخًا عميقًا بين المجتمعات سيستمر لأجيال.
حتى لو تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، يبقى السؤال مطروحًا: كيف يمكن لمجتمعٍ منقسمٍ بهذا القدر أن يعود إلى التعايش السلمي والتعاون الاقتصادي؟ تُظهر تجارب رواندا والبوسنة وغيرهما من مجتمعات ما بعد الصراع أن المصالحة ممكنة، لكنها تستغرق عقودًا وتتطلب جهدًا سياسيًا فاعلًا - وهو أمرٌ لا يُتوقع حدوثه حاليًا في السودان.
خامسًا: الاعتماد على صادرات السلع يُديم التخلف. هيكل صادرات السودان - الذهب والسمسم والصمغ العربي والماشية - نموذجي لمصدر سلع دون تصنيع. تتميز هذه المنتجات بانخفاض قيمتها المضافة، وتقلب أسعارها، وقلة فرص العمل. كما أنها عرضة لسيطرة النخب وأمراء الحرب. تتطلب التنمية الاقتصادية المستدامة التصنيع والتنويع وسلاسل القيمة - وهي أمورٌ مستحيلة في السودان الذي مزقته الحرب. لقد دمرت الحرب القاعدة الصناعية الضعيفة أصلًا؛ وستستغرق إعادة الإعمار عقودًا.
سادسًا: تُصعّب العقوبات الدولية القائمة حتى على الشركات ذات النوايا الحسنة. تشمل عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حظرًا على الأسلحة، وحظرًا على السفر، وتجميدًا لأصول الأفراد، وقيودًا على المعاملات المالية. وبينما تستهدف هذه العقوبات رسميًا قطاعات وأفرادًا محددين فقط، إلا أنها في الواقع تُشكّل رادعًا لجميع الأنشطة التجارية. تتجنب البنوك والشركات التعامل مع السودان خوفًا من انتهاكات الامتثال. هذا يعني أنه حتى لو أرادت شركة سودانية التصدير بشكل قانوني، فستواجه صعوبة في العثور على بنك دولي مستعد لمعالجة المعاملات أو مزود خدمات لوجستية مستعد لنقل البضائع.
تدور النقاشات المثيرة للجدل حول مسألة المسؤولية والحل. هل الغرب مُلزم بمساعدة السودان، أم أن هذه أزمة "أفريقية" يجب أن يُحلها الأفارقة؟ هل ينبغي تشديد العقوبات للضغط على الأطراف المتحاربة، أم أنها ستعيق وصول المساعدات الإنسانية؟ هل ينبغي إجراء مفاوضات مع أمراء الحرب لتمكين منظمات الإغاثة من الوصول، أم أن هذا سيُضفي الشرعية على مجرمي الحرب؟ هذه الأسئلة لا إجابات سهلة عليها، والمجتمع الدولي لا يزال منقسمًا ومُشلولًا.
الأهداف المتضاربة واضحة: المساعدات الإنسانية الفورية مقابل بناء الدولة على المدى الطويل؛ المفاوضات مع الأطراف المتحاربة مقابل العدالة للضحايا؛ التركيز على المراكز الحضرية مقابل المناطق الريفية؛ الاستثمار في البنية التحتية مقابل البرامج الاجتماعية. في ظل الحرب الراهنة، تُعطى الأولوية حتمًا للبقاء؛ وتُعتبر قضايا التنمية الاستراتيجية ترفًا. ولكن بدون منظور طويل الأمد، سيبقى السودان عالقًا في دوامة دولة فاشلة.
خبرتنا في الاتحاد الأوروبي وألمانيا في تطوير الأعمال والمبيعات والتسويق
التركيز على الصناعة: B2B، والرقمنة (من الذكاء الاصطناعي إلى الواقع المعزز)، والهندسة الميكانيكية، والخدمات اللوجستية، والطاقات المتجددة والصناعة
المزيد عنها هنا:
مركز موضوعي يضم رؤى وخبرات:
- منصة المعرفة حول الاقتصاد العالمي والإقليمي والابتكار والاتجاهات الخاصة بالصناعة
- مجموعة من التحليلات والاندفاعات والمعلومات الأساسية من مجالات تركيزنا
- مكان للخبرة والمعلومات حول التطورات الحالية في مجال الأعمال والتكنولوجيا
- مركز موضوعي للشركات التي ترغب في التعرف على الأسواق والرقمنة وابتكارات الصناعة
الأزمة الإنسانية والاقتصاد: ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الشتات؟
بين الواقع المرير والأمل: مسارات التنمية الممكنة حتى عام 2035
التوقعات للسودان قاتمة، لكنها لا تخلو من البدائل. ثلاثة سيناريوهات ناشئة، تُحدد مستقبلًا مختلفًا جذريًا.
السيناريو الأول: حالة فشل دائمة
في هذا السيناريو المتشائم، وإن كان واقعيًا للأسف، تستمر الحرب الأهلية لسنوات دون أن يحقق أي من الجانبين نصرًا عسكريًا حاسمًا. ينقسم السودان إلى مناطق نفوذ تسيطر عليها ميليشيات مختلفة وأمراء حرب وجهات فاعلة أجنبية. يترسخ اقتصاد الحرب، القائم على الذهب والتهريب والدعم الخارجي. تصبح الكارثة الإنسانية دائمة. لا يزال الملايين في مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة التي تزداد عدائية. يعتاد المجتمع الدولي على الأزمة ويقلص مساعداته غير الكافية أصلًا. يصبح السودان "صومالًا ثانيًا" أو "يمنًا" - دولة فاشلة بشكل دائم على هامش المجتمع الدولي. في هذا السيناريو، يصبح أي تنمية اقتصادية مستحيلة؛ ويظل البلد منطقة حرب وكارثة إنسانية في المستقبل المنظور. سيكون توسع الشركات السودانية في أوروبا سخيفًا تمامًا مثل تخيل قراصنة صوماليين يفتحون متاجر في هامبورغ.
السيناريو الثاني: استقرار هش وإعادة بناء بطيئة
في هذا السيناريو المتفائل إلى حد ما، يُتوصّل إلى وقف إطلاق نار هشّ خلال السنوات القادمة، ربما بوساطة من الاتحاد الأفريقي أو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) أو قوى دولية. تتفق الأطراف المتحاربة على تقاسم السلطة أو تشكيل اتحاد فيدرالي ذي مناطق حكم ذاتي. تحت إشراف دولي، تبدأ عملية إعادة الإعمار، بناءً على تخفيف أعباء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لعام ٢٠٢١. تُقدّم بنوك التنمية الدولية والجهات المانحة الثنائية مليارات الدولارات. تُعطى الأولوية لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، ومرافق الصحة والتعليم، والزراعة.
في هذا السيناريو، قد يشهد السودان انتعاشًا متواضعًا بحلول عامي 2030 و2035. تُظهر حسابات النماذج أن استعادة الإنتاجية الزراعية إلى مستويات ما قبل الحرب واستثمار ما يقارب مليار دولار أمريكي في البنية التحتية من شأنهما الحد من الفقر بمقدار 1.9 مليون شخص. ويمكن للاقتصاد أن ينمو بنسبة 3-5% سنويًا، ولكن بالنظر إلى الخسائر الفادحة، فإن هذا لن يمثل سوى انتعاش بطيء. وسيظل السكان فقراء إلى حد كبير، وسيظل السودان نموذجًا من البلدان الأقل نموًا، معتمدًا على صادرات السلع الأساسية والمساعدات الدولية.
في هذا السيناريو، قد يكون هناك عدد قليل من الشركات السودانية - تعمل أساسًا في مجال الإنتاج الزراعي (الصمغ العربي والسمسم) أو في قطاع الخدمات (مثل الشركات الناشئة التي أسسها المغتربون) - التي تُصدر كميات محدودة. ومع ذلك، حتى في هذه الحالة، ستكون هذه المنتجات منتجات متخصصة، وليست حملة تصدير واسعة النطاق. سيكون دخول السوق الأوروبية شاقًا، ويتطلب سنوات من التحضير والشهادات ورأس المال. في أحسن الأحوال، قد تظهر المنتجات السودانية الحاصلة على شهادة التجارة العادلة في متاجر متخصصة، تُسوّق بقصة إعادة الإعمار - على غرار قهوة رواندا أو الحرف اليدوية البوسنية بعد النزاعات هناك. لا مجال لـ"غزو" السوق الأوروبية.
السيناريو 3: النهضة التحويلية
في هذا السيناريو المتفائل، وإن كان مستبعدًا للغاية، تنتهي الحرب سريعًا باتفاق سلام شامل تدعمه حركة واسعة من المجتمع المدني. وتتولى السلطة حكومة انتقالية ديمقراطية، تضم المجتمع المدني. وقد تأثر المجتمع الدولي بهذا التغيير في المسار، فحشد دعمًا هائلًا على غرار "خطة مارشال للسودان". وتُنشأ لجان الحقيقة والمصالحة، على غرار لجان رواندا أو جنوب أفريقيا. وتتدفق الاستثمارات إلى التعليم والصحة والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية.
يُسخّر السودان إمكاناته الزراعية الهائلة - 85 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وإمكانية الوصول إلى نهر النيل، ومناخ مناسب - ليصبح "سلة خبز شرق أفريقيا". ويجري تقنين إنتاج الذهب وتنظيمه، مع تدفق الإيرادات إلى ميزانية الدولة. ويُنشئ جيل شاب مُلِمٌّ بالتكنولوجيا شركات ناشئة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة. ويعود السودانيون في الشتات برأس المال والخبرة. وبحلول عام 2035، سيكون السودان دولة متوسطة الدخل ذات ديمقراطية فاعلة، واقتصاد متنوع، وطبقة متوسطة متنامية.
في هذا السيناريو، يُمكن للشركات السودانية بالفعل استهداف الأسواق العالمية - مُنتجو الأغذية الذين يُصدرون المنتجات العضوية إلى أوروبا؛ وشركات تكنولوجيا المعلومات التي تُقدم خدمات لعملاء دوليين؛ وشركات الخدمات اللوجستية التي تستفيد من موقع السودان الاستراتيجي بين أفريقيا والشرق الأوسط. ومع ذلك، حتى في هذا السيناريو الأكثر تفاؤلاً، سيستغرق هذا التطور ما بين 10 و15 عامًا، ويتطلب شروطًا أساسيةً مُهمة.
سيناريوهات السودان: فرصة للتنمية أم فشل دائم؟
من المرجح أن يكون الواقع بين السيناريوهين الأول والثاني: وقف إطلاق نار هش بعد سنوات من الحرب، تليها عملية إعادة إعمار شاقة وتفتقر إلى التمويل الكافي. الاضطرابات المحتملة عديدة: فالصدمات المناخية (الجفاف والفيضانات) قد تُعرّض الأمن الغذائي الهش أصلاً للخطر؛ والصراعات الإقليمية (مثل تجدد الحرب الأهلية في جنوب السودان أو عدم الاستقرار في إثيوبيا) قد تمتد إلى السودان؛ والأزمات الاقتصادية العالمية قد تُؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار السلع الأساسية وتقليص مساعدات التنمية؛ والتغيرات التكنولوجية (مثل بدائل الصمغ العربي) قد تُدمر أسواق التصدير السودانية.
قد يكون للتغييرات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تأثيرٌ أيضًا: إذ ستُصعّب القواعد الأكثر صرامةً المتعلقة بالمعادن المتنازع عليها، وإثبات المنشأ، والاستدامة وصولَ المصدرين السودانيين إلى الأسواق الأوروبية. في الوقت نفسه، يُمكن لبرامج الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تعزيز التنمية الأفريقية - مثل مبادرة البوابة العالمية - أن تُتيح نظريًا فرصًا إذا استوفى السودان الحد الأدنى من المعايير السياسية والاقتصادية.
الوضع الجيوسياسي غير مستقر أيضًا. للصين وروسيا مصالح تاريخية في السودان (النفط، والتعدين، والوصول إلى موانئ البحر الأحمر)، لكن استعدادهما لدعم دولة مزقتها الحرب محدود. دول الخليج (الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية) جزء من المشكلة (توريد الأسلحة، وتهريب الذهب)، وشركاء محتملون لإعادة الإعمار. استبعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة السودان إلى حد كبير، لكنهما قد يُظهران اهتمامًا متجددًا في حال حدوث تغيير سياسي، لا سيما في ظلّ ضبط الهجرة.
باختصار، يواجه السودان طريقًا طويلًا وشاقًا. في أفضل السيناريوهات - سلام هشّ وإعادة إعمار دولية - سيُحرز تقدمًا متواضعًا حتى عام ٢٠٣٥، وسيبقى دولة نامية منخفضة الدخل. أما في أسوأها - استمرار الحرب الأهلية - فسيُصبح السودان دولةً فاشلةً دائمة. ولن تتمكن الشركات السودانية، في أي سيناريو واقعي، من غزو الأسواق الأوروبية بشكل كبير أو اتخاذ ألمانيا "نقطة انطلاق" خلال السنوات العشر القادمة. تبقى الفكرة كما هي: وهمٌ بعيدٌ كل البعد عن الواقع الاقتصادي.
النتيجة المرة: لا بلد لرجال الأعمال
لا بد أن يكون التقييم النهائي صادمًا: السودان، في وضعه الحالي، ليس مكانًا مناسبًا لطموحات ريادة الأعمال، ناهيك عن توسع الأعمال التجارية الدولية. ويؤدي التحليل الشامل إلى عدة نتائج رئيسية تهمّ صناع القرار السياسي والفاعلين الاقتصاديين، وكذلك الجاليات السودانية في الخارج.
أولاً: الاقتصاد السوداني ليس نظاماً فعالاً حالياً. ما يحدث في السودان ليس اقتصاداً بالمعنى الحديث - بأسواق ومؤسسات ويقين قانوني وتقسيم عمل - بل اقتصاد حرب، ينهب فيه العسكريون الموارد، ويكافح السكان من أجل البقاء، وينهار فيه النشاط الإنتاجي إلى حد الكفاف. إن الحديث عن "تطوير السوق" أو "التوسع" من هذا المنطلق يُسيء فهم أساس النشاط الاقتصادي.
ثانيًا، إن مسألة إمكانية توسع الصناعات السودانية نحو أوروبا مسألةٌ معيبة. فهي تفترض وجود شركات سودانية عاملة ذات قدرة إنتاجية، وقدرة على التصدير، وخبرة تجارية استراتيجية. والحقيقة هي أن الشركات القليلة التي نجت تُكافح من أجل بقائها. فالمشاريع الصغيرة الجديدة التي ظهرت خلال الحرب تُلبي الاحتياجات المحلية الأساسية في ظل ظروف بدائية للغاية. ولا يمتلك أيٌّ منها الموارد أو رأس المال أو الخبرة اللازمة للأعمال التجارية الدولية.
ثالثًا، حتى في القطاعات القابلة للتصدير نظريًا - كالصمغ العربي والسمسم والذهب والثروة الحيوانية - تُعيق العقبات الهيكلية أيَّ توسعٍ تصديريٍّ كبير. تشمل هذه العقبات: فقدان السيطرة على مناطق الإنتاج بسبب الأعمال العدائية، وتعطل سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، وتراجع الجودة ونقص الشهادات، والعقوبات الدولية ومخاطر الامتثال، والتضخم المفرط وانخفاض قيمة العملة، وانهيار البنوك واستحالة المدفوعات الدولية، وتضرر السمعة نتيجة ارتباطها بمناجم الحرب والصراع. لا يمكن التغلب على هذه العقبات من خلال التسويق أو تطوير الأعمال؛ فهي مشاكل جوهرية ومنهجية لا يمكن حلها إلا من خلال السلام وإعادة بناء الدولة وسنوات من التطوير المؤسسي.
رابعًا: إن دور "الشريك الألماني في التسويق والعلاقات العامة وتطوير الأعمال" هو، إن وُجد، دور مستشار في مجال الواقع. على أي مزود خدمات ألماني ذي سمعة طيبة أن يشرح للسودانيين أن التوسع في أوروبا مستحيل في ظل الظروف الحالية، وأن جميع الموارد يجب أن تُركز على البقاء، والمساعدات الإنسانية، والتحضير لإعادة الإعمار على المدى الطويل. لا يمكن للتسويق أن يُنتج منتجات غير موجودة. لا يمكن للعلاقات العامة أن تُحسّن صورةً تضررت بشدة جراء الحرب والجوع والفظائع. لا يمكن لتطوير الأعمال أن يُبرم صفقاتٍ لا أساس لها.
خامسًا: تمتد التداعيات طويلة المدى لانهيار السودان إلى ما هو أبعد من حدوده. فمع وجود 12.9 مليون لاجئ ونازح داخلي، يُزعزع الصراع استقرار المنطقة بأسرها، حيث تُثقل تدفقات السودانيين كاهل مصر وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا. وستُسبب المجاعة أضرارًا صحية ونمائية طويلة الأمد لملايين الأطفال. كما يُعيق انهيار السودان التكامل الاقتصادي الإقليمي، على سبيل المثال من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. فالسودان ليس كارثة وطنية فحسب، بل كارثة إقليمية ذات تداعيات عالمية (الهجرة، والتطرف، والتكاليف الإنسانية).
سادسًا: التداعيات الاستراتيجية واضحة لمختلف الجهات الفاعلة. بالنسبة للشركات الأوروبية والألمانية: السودان ليس سوقًا، فلا يوجد فيه ما يستحق الشراء أو البيع. ينبغي أن يكون التعاون إنسانيًا بحتًا، أو - بالنسبة لشركات البناء ومتخصصي البنية التحتية - موجهًا نحو إعادة الإعمار طويلة الأجل بعد الحرب، على غرار ما تفعله الشركات فيما يتعلق بإعادة إعمار أوكرانيا. بالنسبة لصانعي القرار السياسي في ألمانيا والاتحاد الأوروبي: لا يحتاج السودان إلى ترويج تجاري، بل إلى وساطة في النزاعات، ومساعدات إنسانية، واستراتيجية تنمية طويلة الأجل. ينبغي أن تظل العقوبات الحالية موجهة للتأثير على أمراء الحرب دون عرقلة المساعدات الإنسانية. بالنسبة للمستثمرين الدوليين: السودان ليس خيارًا متاحًا في المستقبل المنظور. فالمخاطر السياسية في أقصاها، وسيادة القانون غائبة، ومصادرة الممتلكات والعنف واردان دائمًا. بالنسبة لمجتمعات الشتات السوداني: المشاركة مهمة لإعادة الإعمار طويلة الأجل، ولكن في ظل ظروف واقعية. ينبغي أن تركز استثمارات الشتات على التعليم والصحة والمجتمع المدني، وليس على الصفقات التجارية قصيرة الأجل.
سابعًا: ثمة مفارقة مريرة في السؤال الأصلي. ففكرة أن الشركات السودانية قادرة على "غزو" أوروبا تعكس ديناميكيات القوة الفعلية. تاريخيًا، استغلت القوى الاستعمارية الأوروبية - بريطانيا العظمى وفرنسا - أفريقيا وهيمنت عليها. وحتى اليوم، تتدفق المواد الخام من أفريقيا إلى أوروبا، بينما تتدفق السلع النهائية ورأس المال في الاتجاه المعاكس - وهو تفاوت هيكلي يتفاقم، لا يتراجع. والسودان مثال صارخ على بلد يقع في أسفل هذا الهرم: فقير، مزقته الحروب، معتمد على الموارد، يفتقر إلى القدرات التكنولوجية أو المؤسساتية. إن فكرة أن مثل هذه البلدان قادرة على "غزو" الأسواق الأوروبية المتقدمة تتجاهل تمامًا هذه الحقائق الهيكلية.
لذا، فإن التقييم النهائي هو: السودان ليس شريكًا لتوسيع الأعمال، بل هو حالة طوارئ إنسانية ذات أبعاد تاريخية. يجب أن تكون الأولوية لإنهاء الحرب، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وبناء دولة مستدامة. فقط عندما تتحقق هذه الشروط الأساسية - وهذا سيستغرق عقودًا في أحسن الأحوال - يمكن معالجة التساؤلات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والصادرات والتكامل الدولي بشكل هادف. وحتى ذلك الحين، يظل أي نقاش حول اختراق السوق السودانية في أوروبا غير واقعي فحسب، بل ومثيرًا للسخرية أيضًا في ضوء المعاناة الهائلة للشعب السوداني.
إن التوصية الاستراتيجية لجميع الأطراف المعنية واضحة: الحفاظ على وجهة نظر واقعية، وعدم إثارة الآمال الكاذبة، وتحديد الأولويات الإنسانية والاستعداد للطريق الطويل والشاق لإعادة الإعمار - ولكن لا تقم بمغامرات تجارية في بلد لا يوجد حاليا إلا كمنطقة حرب.
نصيحة - التخطيط - التنفيذ
سأكون سعيدًا بالعمل كمستشار شخصي لك.
الاتصال بي تحت Wolfenstein ∂ xpert.digital
اتصل بي تحت +49 89 674 804 (ميونيخ)